على الرغم من أنّ زيارات المسؤولين الأوروبيين، ولا سيما الفرنسيين، إلى لبنان تتكرّر باستمرار، وتكاد تكون دورية، تبدو زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو المرتقبة الجمعة، والتي قالت السفارة الفرنسية إنها تأتي ضمن جولة إقليمية تشمل الشرق الأدنى والأوسط، تبدو مختلفة عن كلّ ما عداها، سواء من حيث السياق، أو التوقيت، أو حتى الدلالات، التي يرتفع فيها سقف “الشروط” على حساب “تفهّم” خصوصية التوازنات.
صحيح أنّ عناوين الزيارة التي وردت في البيان الذي أصدرته السفارة الفرنسية بدت مكرّرة، من دعم فرنسا لسيادة لبنان، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني 2024، والقرارات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لاستعادة حصر السلاح في يد الدولة، فضلاً عن بحث التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية، وكذلك مناقشة الإصلاحات المالية اللازمة لعقد مؤتمر دولي حول إعادة إعمار لبنان بعد العدوان الإسرائيلي.
لكن، خلف هذه العناوين، ثمّة خطوط جديدة تُرسَم، قوامها أنّ باريس لم تعد تفصل بين الأمن والمال، بمعنى أنّ “السيادة” باتت في قاموس المجتمع الدولي، شرطًا لتدفق الدعم لا نتيجة له. وتكمن أهمية ذلك في التوقيت شديد الدلالة، ليس قبل مؤتمر دعم الجيش وقوات الأمن فحسب، ولكن أيضًا قبيل وصول بعثة صندوق النقد الدولي بين 9 و13 شباط. فهل تحوّل ملف “حصرية السلاح” من بندٍ سيادي يُدار داخليًا وفق إيقاع التسويات، إلى معيارٍ ماليّ خارجي تُقاس عليه جدية الدولة وقدرتها على إنتاج قرار؟
ماذا تريد باريس عمليًا؟
إذا كان لبنان اعتاد في السنوات الماضية على “خطاب الدعم” الفرنسي، في سياق مبادرات باريس الدائمة لمساعدة الدولة اللبنانية، فإن ما يميّز المرحلة الحالية هو انتقال باريس، ومعها المجتمع الدولي برمّته، إلى خطاب “الربط”، إن صحّ التعبير، بمعنى ربط الأمن بالإصلاح، وربط إصلاح الدولة بقدرتها على إدارة قرارها السيادي، وربط أي مساعدات نوعية للجيش ببيئة سياسية تسمح للجيش أن يعمل من دون أن يتحول إلى طرف في انقسام داخلي أو إلى أداة في مواجهة مفتوحة.
لعلّ هذا التحوّل يشكّل ترجمة “عملية” هذه المرّة، للمقولة التي كرّرها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان “ساعدوا أنفسكم لنساعدكم”، وبالتالي، فهو لا يعني أنّ فرنسا قررت إدارة لبنان بدلًا عن قادته وسياسيّيه، لكنه يعني أنها تريد سقفًا واضحًا لأي انخراط، والحدّ الأدنى المطلوب في هذا السياق هو خارطة طريق قابلة للتسويق دوليًا، من أجل تثبيت وقف الأعمال العدائية، وتفاهمات تترجَم على الأرض، على مستوى ملف “حصرية السلاح”.
بهذا المعنى، فإنّ باريس تنضمّ إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول في “الضغط” على لبنان، من أجل القيام بخطوات ملموسة في ملف “حصرية السلاح”، حتى لا تبقى الخطط حبرًا على ورق، وهي تريد إخراج الملف من المناكفات اليومية إلى مسار تراكمي، بمعايير واضحة، ولو على مراحل. لكن باريس تعرف أنّ الأمور ليست بهذه السهولة، فكل خطوة إلى الأمام تقابلها خطوة إلى الخلف، لأن التوازنات الداخلية لا تنتج قرارًا واحدًا بل سلسلة مقايضات.
“السلاح” مفتاح “التمويل”؟
بهذا المعنى، تبدو زيارة بارو أقرب إلى محاولة “ترتيب الإيقاع”، لكنّها تركت سلفًا انطباعًا واضحًا بأنّ ملف “السلاح” لم يعد محصورًا بكونه مسألة سيادية-داخلية تُحلّ ضمن ميزان القوى المحلي والإقليمي، بل صار يُستخدم خارجيًا كمفتاح لتحديد مستوى الانفتاح المالي، سواء على مستوى منسوب الدعم للجيش، أو المشاركة في مؤتمرات المانحين، أو حتى دينامية صندوق النقد الذي يحتاج إلى حدّ أدنى من الاستقرار كي يستثمر في برنامج طويل النفس.
من هنا، يمكن فهم تحوّل النقاش إلى كيفية إدارة مرحلة “حصر السلاح”، فالعواصم الغربية تبحث عن ضمانة عملية بعدم عودة لبنان إلى الحرب أو إلى حافة الحرب، وعدم استخدام مؤسسات الدولة واجهة بينما القرار الفعلي خارجها. لكنّ إشكالية هذا التحول أنه يضع الحكومة ورئاسة الجمهورية أمام اختبار مزدوج: كيف تُقنع الخارج بأن هناك مسارًا سياديًا حقيقيًا، من دون أن تُظهر الداخل وكأنه يُسلَّم قراره تحت ضغط المال؟
انطلاقًا من ذلك، يبدو أنّ التحدّي الحقيقي أمام الدولة هو تحويل “حصر السلاح” من عنوان صدام إلى عنوان إدارة انتقالية، لأنّ المعادلة التي تترتّب على ذلك هي التي تحدّد نتائج زيارة بارو، سواء لجهة تحقيق تقدّم في المسار، ما يفتح باب الدعم والمساعدات، وإما إضافة ضغوط فوق طاولة مثقلة أصلًا، ولو أنّ المفارقة التي يتوقف عندها كثيرون تبقى في أنّ الضغوط على لبنان لا تقابلها ضغوط موازية على إسرائيل، رغم أنّها من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
ثمّة من يراهن على أن باريس تستطيع لعب دور “الوسيط الصلب”، بحيث تمنح الجيش دعمًا أكبر، وتُقنع واشنطن بهوامش زمنية، وتفتح قنوات مع القوى الداخلية لمنع الانفجار. لكن هذا الرهان، حتى لو صحّ، لن يحقّق غاياته، ما لم يتّفق اللبنانيون أولًا، فالخارج يمكن أن يخفف الضغط أو يرفعه، لكنه لا يستطيع إنتاج توافق لبناني من عدم، أي إن الباب الحقيقي لأي انفراج لن يفتحه بارو ولا صندوق النقد، بل قرار داخلي في المقام الأول!
صحيح أنّ عناوين الزيارة التي وردت في البيان الذي أصدرته السفارة الفرنسية بدت مكرّرة، من دعم فرنسا لسيادة لبنان، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في تشرين الثاني 2024، والقرارات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لاستعادة حصر السلاح في يد الدولة، فضلاً عن بحث التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية، وكذلك مناقشة الإصلاحات المالية اللازمة لعقد مؤتمر دولي حول إعادة إعمار لبنان بعد العدوان الإسرائيلي.
لكن، خلف هذه العناوين، ثمّة خطوط جديدة تُرسَم، قوامها أنّ باريس لم تعد تفصل بين الأمن والمال، بمعنى أنّ “السيادة” باتت في قاموس المجتمع الدولي، شرطًا لتدفق الدعم لا نتيجة له. وتكمن أهمية ذلك في التوقيت شديد الدلالة، ليس قبل مؤتمر دعم الجيش وقوات الأمن فحسب، ولكن أيضًا قبيل وصول بعثة صندوق النقد الدولي بين 9 و13 شباط. فهل تحوّل ملف “حصرية السلاح” من بندٍ سيادي يُدار داخليًا وفق إيقاع التسويات، إلى معيارٍ ماليّ خارجي تُقاس عليه جدية الدولة وقدرتها على إنتاج قرار؟
ماذا تريد باريس عمليًا؟
إذا كان لبنان اعتاد في السنوات الماضية على “خطاب الدعم” الفرنسي، في سياق مبادرات باريس الدائمة لمساعدة الدولة اللبنانية، فإن ما يميّز المرحلة الحالية هو انتقال باريس، ومعها المجتمع الدولي برمّته، إلى خطاب “الربط”، إن صحّ التعبير، بمعنى ربط الأمن بالإصلاح، وربط إصلاح الدولة بقدرتها على إدارة قرارها السيادي، وربط أي مساعدات نوعية للجيش ببيئة سياسية تسمح للجيش أن يعمل من دون أن يتحول إلى طرف في انقسام داخلي أو إلى أداة في مواجهة مفتوحة.
لعلّ هذا التحوّل يشكّل ترجمة “عملية” هذه المرّة، للمقولة التي كرّرها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان “ساعدوا أنفسكم لنساعدكم”، وبالتالي، فهو لا يعني أنّ فرنسا قررت إدارة لبنان بدلًا عن قادته وسياسيّيه، لكنه يعني أنها تريد سقفًا واضحًا لأي انخراط، والحدّ الأدنى المطلوب في هذا السياق هو خارطة طريق قابلة للتسويق دوليًا، من أجل تثبيت وقف الأعمال العدائية، وتفاهمات تترجَم على الأرض، على مستوى ملف “حصرية السلاح”.
بهذا المعنى، فإنّ باريس تنضمّ إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول في “الضغط” على لبنان، من أجل القيام بخطوات ملموسة في ملف “حصرية السلاح”، حتى لا تبقى الخطط حبرًا على ورق، وهي تريد إخراج الملف من المناكفات اليومية إلى مسار تراكمي، بمعايير واضحة، ولو على مراحل. لكن باريس تعرف أنّ الأمور ليست بهذه السهولة، فكل خطوة إلى الأمام تقابلها خطوة إلى الخلف، لأن التوازنات الداخلية لا تنتج قرارًا واحدًا بل سلسلة مقايضات.
“السلاح” مفتاح “التمويل”؟
بهذا المعنى، تبدو زيارة بارو أقرب إلى محاولة “ترتيب الإيقاع”، لكنّها تركت سلفًا انطباعًا واضحًا بأنّ ملف “السلاح” لم يعد محصورًا بكونه مسألة سيادية-داخلية تُحلّ ضمن ميزان القوى المحلي والإقليمي، بل صار يُستخدم خارجيًا كمفتاح لتحديد مستوى الانفتاح المالي، سواء على مستوى منسوب الدعم للجيش، أو المشاركة في مؤتمرات المانحين، أو حتى دينامية صندوق النقد الذي يحتاج إلى حدّ أدنى من الاستقرار كي يستثمر في برنامج طويل النفس.
من هنا، يمكن فهم تحوّل النقاش إلى كيفية إدارة مرحلة “حصر السلاح”، فالعواصم الغربية تبحث عن ضمانة عملية بعدم عودة لبنان إلى الحرب أو إلى حافة الحرب، وعدم استخدام مؤسسات الدولة واجهة بينما القرار الفعلي خارجها. لكنّ إشكالية هذا التحول أنه يضع الحكومة ورئاسة الجمهورية أمام اختبار مزدوج: كيف تُقنع الخارج بأن هناك مسارًا سياديًا حقيقيًا، من دون أن تُظهر الداخل وكأنه يُسلَّم قراره تحت ضغط المال؟
انطلاقًا من ذلك، يبدو أنّ التحدّي الحقيقي أمام الدولة هو تحويل “حصر السلاح” من عنوان صدام إلى عنوان إدارة انتقالية، لأنّ المعادلة التي تترتّب على ذلك هي التي تحدّد نتائج زيارة بارو، سواء لجهة تحقيق تقدّم في المسار، ما يفتح باب الدعم والمساعدات، وإما إضافة ضغوط فوق طاولة مثقلة أصلًا، ولو أنّ المفارقة التي يتوقف عندها كثيرون تبقى في أنّ الضغوط على لبنان لا تقابلها ضغوط موازية على إسرائيل، رغم أنّها من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
ثمّة من يراهن على أن باريس تستطيع لعب دور “الوسيط الصلب”، بحيث تمنح الجيش دعمًا أكبر، وتُقنع واشنطن بهوامش زمنية، وتفتح قنوات مع القوى الداخلية لمنع الانفجار. لكن هذا الرهان، حتى لو صحّ، لن يحقّق غاياته، ما لم يتّفق اللبنانيون أولًا، فالخارج يمكن أن يخفف الضغط أو يرفعه، لكنه لا يستطيع إنتاج توافق لبناني من عدم، أي إن الباب الحقيقي لأي انفراج لن يفتحه بارو ولا صندوق النقد، بل قرار داخلي في المقام الأول!




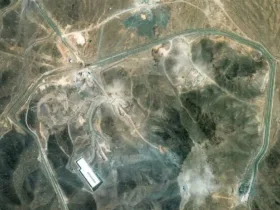



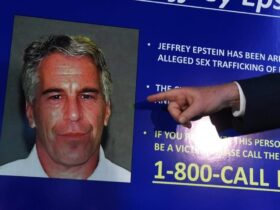



اترك ردك