لكن ما يشبه “حلّ الأزمات اليومية” يتحوّل سجالاً بين خسائر للمال العام وتهديد للسلامة، وأبنية بلا شبكة صرف، وشوارع قابلة للانهيار عند أول شتوة. فمن 2019 إلى 2024، سُجّل أكثر من 350 بلاغاً عن سرقات أغطية مجاري وكابلات نحاسية وبطاريات شمسية. بلدياتٌ عدة منها بيروت وطرابلس وبعلبك وفي مناطق اخرى اشتكت من تكرار الحوادث، خاصة على صعيد الريغارات، التي كانت مصيدة لما لا يقل عن 32 شخصا خلال الاشهر الماضية. وفي مختبرات فحص المواد الخردة، يؤكد أصحاب المعامل أن الكيلوغرام الواحد من النحاس يُباع اليوم بما لا يقل عن 10 دولارات، فيما غطاء المجاري الحديديّ يصل ثمنه إلى 50 دولاراً للقطعة الواحدة، ما يفسر الإغراء المرتفع للفاعلين. كما رصد اقتلاع بعض من إشارات السير، التي لم تسلم من خطط هذه العصابات، التي لا توفر المال، بل تزيده عجزًا.
تكلفة الإصلاحات على البلديات تجاوزت في العام الماضي 3 مليارات ليرة بهدف سد الحفر وتركيب أغطية جديدة، في وقت يشكو فيه الأهالي من انقطاع الكهرباء المتكرر نتيجة سرقة كوابل التوزيع. أما شاحنات الإسعاف فباتت تتلقى نداءاتٍ بشكل مستمر لنقل مصابين سقطوا في حفرٍ لا يعلوها غطاء، علما أن الحفر المكشوفة ليست خطراً على المارة فحسب، بل تهدّد بنزح مياه الصرف إلى الطبقات الجوفية إذا انقطع التدفق المائي السطحي.
يمكننا تفسير هذه الظاهرة أيضًا من زاوية حالة اللامساءلة التي باتت سمة للحياة العامة: قلة الضبط البلدي، تأخر القضاء في إصدار الأحكام، وتهاون في تنفيذ الغرامات أو العقوبات، كلها عوامل تشكل حافزًا إضافيًا للمخاطرة بالسرقة. وفي غياب استجابة سريعة وحازمة، يرى الفاعلون أن المكسب المحتمل يفوق خطر الردع القانوني، فتنتشر الممارسات تدريجيًا وتصبح “قاعدة” أكثر منها “استثناء”.
إن السرقات الصغيرة التي تبدو فردية أو فوضوية، ليست بريئة تمامًا ولا عشوائية بالكامل. بل تُشكّل، في الكثير من الأحيان، الحلقة الأولى في سلسلة مدروسة تنتهي في أماكن بعيدة عن عين الدولة. ففي بلدٍ تتشابك فيه الأزمات المالية مع هشاشة الرقابة، تُصبح الخردة بابًا خلفيًا للاقتصاد الموازي. فعمليات الشراء تتم نقدًا، بلا إيصالات أو ضرائب، والتدقيق في مصدر المواد نادر، حتى في المعامل الكبرى. أحيانًا، تصل شحنات النحاس إلى موانئ التصدير كأنها ناتجة عن عمليات “تفكيك مشروع” لمعامل قديمة، بينما تكون في الواقع مستخرَجة من البنى التحتية العامة، ومهرّبة عبر وسطاء يتقنون التمويه القانوني.
وتكمن الخطورة هنا في أن الدولة لا تواجه مجرد لصٍ يسرق غطاء مجرى، بل شبكة تملك قدرة على تصريف المسروقات، وتعرف كيف تُخفي أثرها في بيئة قانونية رخوة. وهو ما يتطلب تغييرًا في مقاربة المعالجة: من ملاحقة السارق إلى تفكيك بنية التهريب كاملة.
من جهة أخرى، تؤشّر الأرقام على تكريس حلٍّ ترقيعيّ مؤقت عبر إعادة تركيب أغطيةٍ رخيصة أو مؤقتة، بينما ينمو الخلل في أماكن أخرى، حتى تتوزّع الأزمة على مساحة أوسع. الحل الجذري يتطلب خارطة طريق شاملة تشمل:
– استحداث برامج تشغيل عاجلة تخلق فرصًا تناسب المهارات المتاحة في المناطق الأكثر تضررًا.
– إطلاق صناديق للتأمين المجتمعي يعوّض المتضررين من سرقات البنية التحتية الصغيرة ويخفّف العبء المالي عن البلديات.
– تفعيل قوانين صارمة للتصدي للشبكات المنظمة المرتبطة بوسطاء الخردة، بما يؤمّن استرجاع الحقوق العامة وإحكام الضبط القضائي.
– تعزيز صيانة البنية التحتية الوقائية عبر مشاريع تشاركية بين الدولة والمجتمع المحلي لتحصين المناهج المائية والكهربائية من العبث.
باختصار، الحلّ لا يبدأ بتقوية سياج غطاء المجاري أو تركيب كاميرات مراقبة فحسب، بل بـاستعادة العقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بالدولة: يوفر له العمل الكريم، ويحميه من المخاطر، ويضمن له شارعًا سليمًا ومستقبلًا دون أن يضطر إلى مقايضة حديده بحياته.










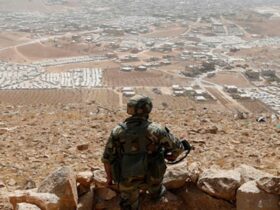
اترك ردك